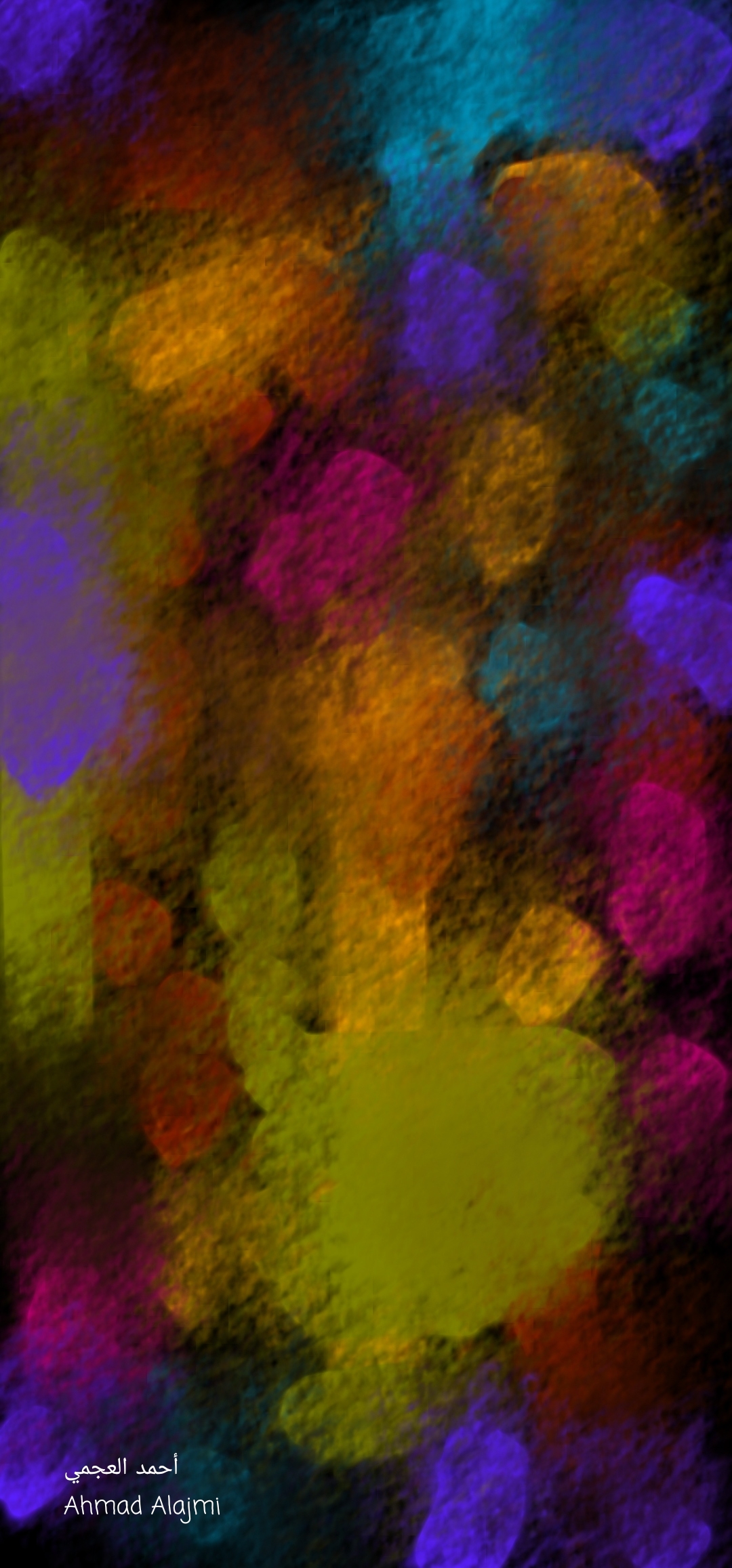بقلم عبد الله جناحي
أحمد العجمي شاعر تمكن أن يشق لنفسه درباً إبداعياً متميزاً، بدأ مشواره – حسب تسلسل الدواوين – من حفر طريق إبداعي غير مختلف كثيراً عن طرق رفاقه سوى في بعض الدلالات أو الثيمات، فالبنية الكبرى لأول ديوان له (أنما هي جلوة ورؤى) الصادر عام1987 م، هي بنية تحتضن الصوفية والسياسية والسريالية المتأثرة بشكل ما بالتجارب العربية الإبداعية، والبنية الكبرى لديوان ( نسل المصابيح) الذي صدر عام 1990م كانت تحمل في أحشائها هواجس الأمة وقضايا العرب مع النـزوع صوب قيمة الحرية ومغلفة أيضا بالصوفية، أما الديوان الثالث (المناسك القرمزية) الصادر عام 1993 م فلقد كانت بنيته الكبرى هي ذاتها بنية النصوص الإبداعية العربية التي آلمتها حرب الخليج الثانية وكانت تحتضن روح الهزيمة أو الهزائم العربية المتتالية، ودون الدخول في التشريح والاستشهاد والإتيان بالأدلة وتحليل وتفكيك بنية هذه النصوص، حيث أن المقام هنا يفرض علينا التركيز على ديوانه الأخير (مساء في يدي) الصادر عام 2003 م- موضوع هذه المحاولة النقدية التأويلية_ نستطيع القول بان الدواوين الثلاثة المذكورة كانت حفراًُ لتشييد الدرب الخاص بالشاعر، حفراً كحفور الآخرين، وان كان البعض حفر عميقاً والبعض الآخر حفر ملتوياً مخفياً.
بيد أن هذا الحفر أو البحث، كان بمثابة تراكماً ومخزوناً ضرورياً، مرجلاً انصهرت فيه لغته الشعرية الحادة في معظم الأحيان، الفاقعة في كل الأحيان حتى في ألوان أغلفة دواوينه!!، كان مختبراً يجرب فيه ذاته، يضيف محلولاً ليكتشف أكسيده فلا يقتنع، فيجرب حمضاً شديد الاحتراق، لغة، ثيمات، دلالات تحرق الشعور وتخلق صوراً غامضة ، كإمرء يصحو متعباً يجاهد أن يتذكر أحلامه فيفشل ولا يحصل سوى على خيوط مبهمة منها وهو واثق بأنه كان حلماً جميلاً أو مخيفاً!!
وكأي تراكم واع يرعاه المبدع القلق، لابد أن يتحول هذا المخاض إلى قفزته النوعية، وهذا ما اعتقد قد حدث للشاعر العجمي في ديوانه الرابع (زهرة الروع) الصادر عام 1995م، حيث بدأ يطفح على سطح البنية الكبرى لهذا الديوان الرجوع إلى الذات والتفكير في الخاص، وكشف الخصوصية الفردية، مشاعراً أو التلذذ بالجسد، إنه ليس التحول النوعي التام نحو الذات إنما بداياته، تماماً كبدايات تحول الماء إلى بخار بعد تراكم الحرارة وهي تغلي الماء فتشاهد فقاعات صغيرة قبل أن تتحول إلى فوران ودخان وبخار يغطي الماء ويخفيه، لتبدأ القفزة الضرورية لانتقال الماء إلى بخار، ولعل ديوانه ( العاشق) الصادر عام 1997م هو بمثابة هذه القفزة إلى عوالم أخرى، لغة شعرية مختلفة تماماً عن دواوينه السابقة، وكأن مخزونه من الصور والدلالات قد انصهر ليتم خلقاً جديداً، فتصبح الأنثى والحب والايروتيكية المخفية وليست الفاضحة والعشق هي عوالمه، بعد أن كان العام هو عوالم نصوصه السابقة، وبالطبع أصبح المكان والأشياء والكائنات المرتبطة بهذه العوالم الجديدة هي التي تخلق الصور الشعرية، وأصبحت لغته أكثر خفة وهدوءاً وشفافية، والنـزوع نحو الذات وعلاقتها بالآخر هو الذي أصبح سائداً، (وربما أنا) كديوان صادر عام 1999م احتضن هذه الذاتية بشكل فاضح وكبير ابتداءً من عنوانه مروراً بمتن الديوان.
:مساء في يدي، افرازات الرجوع إلى الذات
للعام عوالمة وصوره البعيدة نوعما عن عوالم الذات، حيث تختفي هذه الذات ضمن ذوات كثيرة، ولذلك حينما يكون العام مهيمناً في النص الإبداعي تتحول الأشياء والكائنات إلى رموز عامة ودلالات بل وصور كلية ومجردة، فالشجرة تصبح رمزاً للاخضرار والحياة وليست كائناً له كينونته الخاصة، والقناديل ترمز في الهاجس العام إلى الأمل والمستقبل والوعي، والنجوم تعني من خلالها الإصرار والحقيقة والحب والصفاء والجمال، والمساء يصبح رمزاً للهزيمة المؤقتة التي بعدها الانتصار النهاري أو ترميزاً للمسكوت عنه والذي لا يباح، وحتى الحب كمفهوم إنساني يتحول إلى مفهوم كلي، كحب الوطن أو القضية، والحمامة تتحول إلى رمز للسلام، والغيوم تصبح رمزاً لولادة جديدة، مطراً، أملاً، ثورة، وغيرها، وغيرها.
بيد أن الخاص جداً، وعوالم الذات تنقل المفاهيم العامة للرموز إلى صور مختلفة في دلالاتها وتتخلق صوراً جميلة و يصبح المكان أكثر خصوصية بعد أن كان أكثر عمومية، وتصبح الدلالات أكثر خصوصية وذاتية.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية تطفح على سطح الصورة عندما تنتقل البنية الكبرى أو البني الصغرى للنص الإبداعي إلى الذاتية، إلى صور بعيدة عن الهم العام، ولذلك فالشجرة لن تصبح رمزاً عاماً إنما كائناً كلياً له خصوصيته الذاتية البحتة جمالياً ودلالة للشاعر وعوالمه بهدف خلق الصورة الكلية للنص، وكذا الحال القناديل التي تتحول إلى مكون من مكونات أو ضرورات خلق الصورة، وهكذا الحال مع النجوم والليل والحمامة والغيوم.
عند هذا المفصل يصبح التحليل النفسي للأدب قادراً على كشف مكنونات الشاعر ومكونات الصور الشعرية من خلال الدلالات التي تعطيها تلك الصور، كالعزلة والوحدة والخيال… الخ .
:الفردانية تفجر إنسانية الكائنات
في قسم (أعني الشمس) من ديوان (مساء في يدي) تتجلى حالة الفردانية ولعل إهداء هذا القسم يكشف هذه الحالة (لن أجدكم).
فالشاعر وحده يحاور كل هذه الكائنات والأشياء دون مشاركة أحد، وهو في هذه الحالة يبرز متعة الوحدة والعزلة، وجمالها ولذتها، ويحاول أن يرسل إلينا هذه الحالة الإنسانية، بل ويغيضنا ويستفزنا، وأحياناً ينبهنا بهذه اللحظات المهمة للذات الإنسانية، لحظات التأمل الوجودي والتفاعل والتصادق والذوبان والتلاقح مع هذه الأشياء وتحولها إلى جزء أساس للروح، في حين أنها موجودة أمام الجميع وفي كل لحظة ودون أن يقف المرء أمامها ويتصادق معها.
ففي نص ( بحث) يتفاعل مع علب الكارتون وأوراق الشجر المتساقطة، وفي الليل لوحده دون مشاركة أي حياة معه، وكذا الحال في نص (اختيار) حيث يصفعنا بأن أحد مميزات الليل هي تحرير المرء من ظله، إنها صورة قوية لمفهوم الحرية الذاتية، فحتى الظل يصبح مقيداً لها، فالمرء في النهار لن يحقق حريته الكاملة، حيث يصبح هناك ظلٌ يرافقه ويراقبه ويقيد انطلاقاته!!!.
:وحدة و نص جميل
إن جمالية ولذة الذاتية- إذا ما تحررنا من المقاييس الإيديولوجية في الأدب والفن وتعاملنا مع مفهوم الذاتية من بعدها الايجابي- تكمن في أن تنبهنا إلى كثرة من الحالات التي نمر بها دون أن نستشف منها الدلالات الإنسانية الجميلة، ونص (وحدة) في هذا الديوان، أشعرني بهذا الفقدان، فمن منا لم يسمع في الليل ذلك الصوت المزعج لحشرة الليل والذي يستفزك وتحاول أن تبحث عن مصدره لتسكته، وها هو هذا النص يحول ذلك الصوت المزعج إلى دلالة إيروتيكية جميلة، ولكنه يصدمك بأن نداء ذكر حشرة الليل الجنسي هذا لن يتحقق في ظل وجود المرء لوحده دون الآخر الضروري لتجسد تلك الرغبة، ففي ليلة مقمرة وذكر حشرة الليل يصدر أصواتاً لجذب الأنثى، فإذا بالرغبة الإيروتيكية تطفح وحلم الاحتضان يصبح في الواجهة، ولكن بدلاً من تحقيق هذا الحلم الذي هيأ له المكان والقمر ونداءآت ذكر حشرة الليل، يذهب المرء إلى فراشه وحيداً !!.
” كيف أترك – ليلة مقمرة – أليس من الحكمة- أن أحضنك- وأترك الهواء يحرسنا؟ هذا كل ما سمعته من ذكر حشرة الليل – وأنا- ذاهب إلى الفراش- وحدي!” صورة و خيال ودلالات متناقضة ومؤلمة وجميلة ولذيذة!!.
ودون التوسع في تشريح أو تأويل صور النصوص الأخرى من هذا القسم، فأن النماذج التي طرحت تفي بالغرض، فجميع الصور الشعرية التي خلقتها هذه النصوص تشي بالوحدة والعزلة رغم متعة خالقها بالتحاور والتلاقح مع أشيائها الموجودة في كل مكان، في كل مسكن.
إن هذا القسم من الديوان يحتضن من النصوص الذاتية الجريئة التي يمارسها كل إنسان- كل مبدع- كل رسول- كل مبشر- كل قائد، ولكن بمفرده، في عزلته، في لياليه أو في غرفته أو يمكن في حمامه وهو يحاور ذاته أمام مرآته!! دون أن يسمح لنفسه أن يقف متأملاً لوجود هذه الأشياء والحالات الصغيرة الجميلة وعلاقتها بالذات وإشباعها.
” أحيانا
لا أجيد التعبير
عن أحلامي
سوى أمام المرآة
أو مع الفراغ المتبقي”
واعتقد بأن هذه هي إحدى جماليات نصوص هذا الديوان على صعيد الدلالات الايجابية، وأحد المؤشرات المؤدية إلى الألم والخوف من فقدان المشاركة الإنسانية على صعيد الدلالات الأخرى، دون أن أتجرأ في القول بأنها دلالات سلبية حيث أن المسألة بحاجة إلى إعادة النظر في أحقية أن نتهم العزلة أو الوحدة الذاتية بالسلبية لدى المبدع، وذلك بعيداً عن التقييم الذي يمارسه غير الأدبي وغير الفني كالسياسي أو المؤدلج بأفكار اجتماعية وإنسانية لا علاقة مباشرة لها بالإبداع الفني!!.
بيد أن محاولة الشاعر أبراز جمالية حالة الوحدة والعزلة هذه تحتضن في سياق النص فقدان واضح لنقيضها، والرغبة بل الشوق والاشتياق واللهفة والرغبة الخفية المفقودة إلى الأصدقاء، إلى الكائن الإنساني ليشارك باقي الكائنات المحيطة بالشاعر في خلق البهجة أو إضاءة التأمل في الموجودات والأشياء الصغيرة.
“وحيناً أنظر في وجوهكم، إنني أكرر ذلك بحثاً عن ليلة خفيفة ذات طقس رائع، أمضيتها وحدي!” تعبير عن خيال مهيمن عليه وجوه الأصدقاء رغم وحدته وإبراز جماليات الليل والطقس، “ربما أشعر بالحرية، وهو جانبي” تعبير عن أن ظله قد تحول إلى كائن يحسسة بوجود الآخر مما يخلق لديه شعوراً بالحرية، الأمر الذي يعني بالنسبة له الربط العضوي بين قيمة الحرية ووجود الإنسان الجمعي.
“وأنا ذاهب إلى الفراش وحدي” غير إن رغبته الجامحة في وجود الأنثى ، الآخر معه! في الليل و “عندما يبدأ النهار بالانصراف” كثيراً ما “أبحث عن رائحة الأصدقاء” وهل هناك رغبة وشوق للجموع أكثر من البحث عن رائحة المفقود؟.
وفي نصه (متعة) يتجلى الشوق والمتعة لوجود الآخر معه، فلقد كان فرحاً جداً تلك الليلة لأن ابنه كان معه، كائن إنساني أمتعه فوسم عنوان النص ( بالمتعة)
“من منكم
شاهدني البارحة
كنت فرحاً جداً
خاصة
وقتما لامست أناملي
شعر ابني المضي”
:النـزوع نحو الجماعية
إن ما سبق لا يعني بأن نصوص هذا الديوان تتلاعب فقداً مع الأشياء الطبيعية، فرغم أن هذا الديوان عند قراءته لا تلمس ولا تحس بوجود أي كائن بشري مباشر ، فجميع الكلمات والصور الشعرية نابعة من كائنات الطبيعة كالقمر والنجوم والبحر والشمس والشجر.. الخ، غير أن لكل قاعدة شواذ، فنص (ثرثرة) يقدم للمتلقي حالة المبدع في الحانة البليدة ونقاشاته الحمقاء، وفي نص (نقد) يقدم لنا الشاعر بجانب كم كبير من الأشياء الجامدة أو الطبيعية كالعصافير والبحر والشجر والورد والحديقة والسماء والنجوم يقدم لنا استفساراً حول استيعاب (النساء) لمعنى اندماجه مع هذه الكائنات.
“ترى، ماذا لو نظرت الليلة إلى السماء
لاستعيد ذاكرة النجوم
هل ستفهم النساء محاولاتي؟”
وكذلك يبدأ يهتم بقطته المسكينة وهو يفكر بصديقه الليل، أو يدعو لاستمرار تشابك الأيادي وتوتر القلوب وعدم الارتباك، فالجميع في هذه الظلمة مندمجون في أحداث الفيلم، والروحان والجسدان لا يهتمان بما يحدث في الفيلم.
ورغم ذلك ثمة احتجاج جميل من قبل الشاعر تجاه الإنسان الذي يستغل كائناته، خاصة كائناته الليلية التي يتحاور معها وهي رفيقة وحدته، كالنجوم التي يتمنى أن تستمر رمزاً للجمال والحب والوحدة، فهو يتلاعب معها، تارة ” أطعم النجوم لساني”، وتارة يختار نجمة لإضاءة سريره، وتارة ينظر إلى السماء في الليل “لاستعيد ذاكرة النجوم”، وتارة يرى المصابيح الصغيرة تنقط حزنها وتمنع من تطفل النجوم، وتارة يترك الليل النجوم ترقص عارية وتتمنى أن تستحم في بحيرات هذا الكوكب أو تكون دمى لأطفاله. غير أن هناك إنساناً شريراً يحول هذا الكائن الطبيعي الحميمي إلى رمز للقتل والدمار، فالجنرالات هم وحدهم قادرون أن يحولوا النجوم إلى دلالات قبيحة عندما يضعونها فوق أكتافهم!!!، فكلما كثرت جثث قتلاهم كلما ازدادت النجوم على أكتافهم، وهي دلالة معبرة عن مدى تحول الجمال إلى قبح وتحول الخير إلى شر والحب إلى حقد والسلام إلى حرب، وكل ذلك بأيدي الإنسان نفسه.
عند هذا المفصل من الأهمية بمكان أن نؤكد بأن معظم نصوص هذا الديوان رغم فردانيتها أو شخصنة كائنات الطبيعة الجامدة منها أو الحية ما عدا الإنسان منها قد فجرت صور شعرية جميلة بعضها على شكل صدمات وبعضها تفجير للحالة التخيلية، وهي في كل الأحوال تعتبر إحدى الخصائص المتميزة للنص الشعري، ورغم أن التخيل ليس شرطاً كافياً لتحديد ما هو أدبي مادامت هناك تخيلات غير أدبية، ولكنه شرط لازم لوجوده وجودته ولذته، فبدون تخيل لا يوجد أدب،حسب مقولة خوستيه ماريا في كتابه (نظرية اللغة الأدبية)، وكما يتعاطف مع هذا الطرح حازم القرطاجني في مقولته التي تقول بان الشعر هو كلام مخيل، و هكذا ذهب السلجماسي في كتابه (المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع) والذي يؤكد بأن جوهر الشعر هو التخييل.
كما تحتضن هذه النصوص أو بعضها صدمة الخاتمة ، أو غرائبية التعامل مع الكائنات غير الحية وقدرتها على أن تكون أحن وأكثر مشاعراً وعاطفة من الإنسان، وفي كلتا الحالتين فإن هذه الحالة تحقق درجة كبيرة من الجمالية، وكما عبر حازم القرطاجني بأن الغرابة شرط لازم للشعرية، (( فما كان خلياً من الغرابة أجدر ألا يسمى شعراً)) فان هذا الشرط أيضا لازم بكثرة في نصوص ديوان ( ربما أنا)) للشاعر أحمد العجمي.
ولعلنا لا نبالغ كثيراً إذا ما ارتبطنا الدلالات الصادرة عن تعامل الشاعر مع كائنات الطبيعة وتكرارها بل وهيمنتها على كافة نصوص الديوان، بذات الدلالات التي كان الشعراء المتصوفة يقصدونها عند تكرارهم للألفاظ والكلمات ومنها كائنات الطبيعة ، كالياقوتة أو التجلي مع الله و مع الليل ومع السماء والنجوم…الخ، وان كانت لدلالات المتصوفة هذه رمزية خاصة بهم، حيث يستعملون الفاظاً يقصدون بها الكشف عن معاني الموجودات والمقولات الربانية لأنفسهم، فان تكرار الشاعر لذات الألفاظ لابد من أن نتعامل معها من منطلق قصدية الشاعر وتعمده باستخدام (الإشارة على العبارة) حسب مقولة السهرودي، وما يؤكد عدم مبالغتنا هذه بتشبيه بعض نصوص هذا الديوان بنصوص المتصوفة هو الحالة المكانية والزمانية التي تتشظى فيها المتصوف ألغازه اللفظية تلك ، وهي حالة قريبة من حالة الشاعر ونصوصه، فالعزلة الكاملة عبر ذهاب المتصوف لصومعته ليتجلى مع المطلق هي التي تفجر مثل هذه التكرارات للألفاظ والأشياء تعبيراً عن دلالات جوانية باطنية عادة تكون عند آناء الليل حتى أطراف النهار، وهذا ما يؤكد ما أكدنا عليه في سياق هذه الورقة بشان الأبعاد الايجابية للفردانية، حيث في الوحدة والعزلة يكون هناك هاجسان يتصارعان: الوحدة بدلالاتها الضيقة، والنـزوع لمواجهة هذه الوحدة من خلال الفضاء الواسع كدلالة نحو النزوع للحرية والجموع والتحرر من قيد الأجواء الضيقة للوحدة والعزلة، ولقد احتضنت النصوص التي تعاملنا معها من هذا الديوان كإستشهادات كل هذه المعاني والمقاصد لوجود العزلة الفردانية الايجابية وبلغة شعرية ونثرية مكثفة، لدرجة أن كل نص من الممكن أن تطبق عليه مقولة النفري بأنها ((كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة))!!.