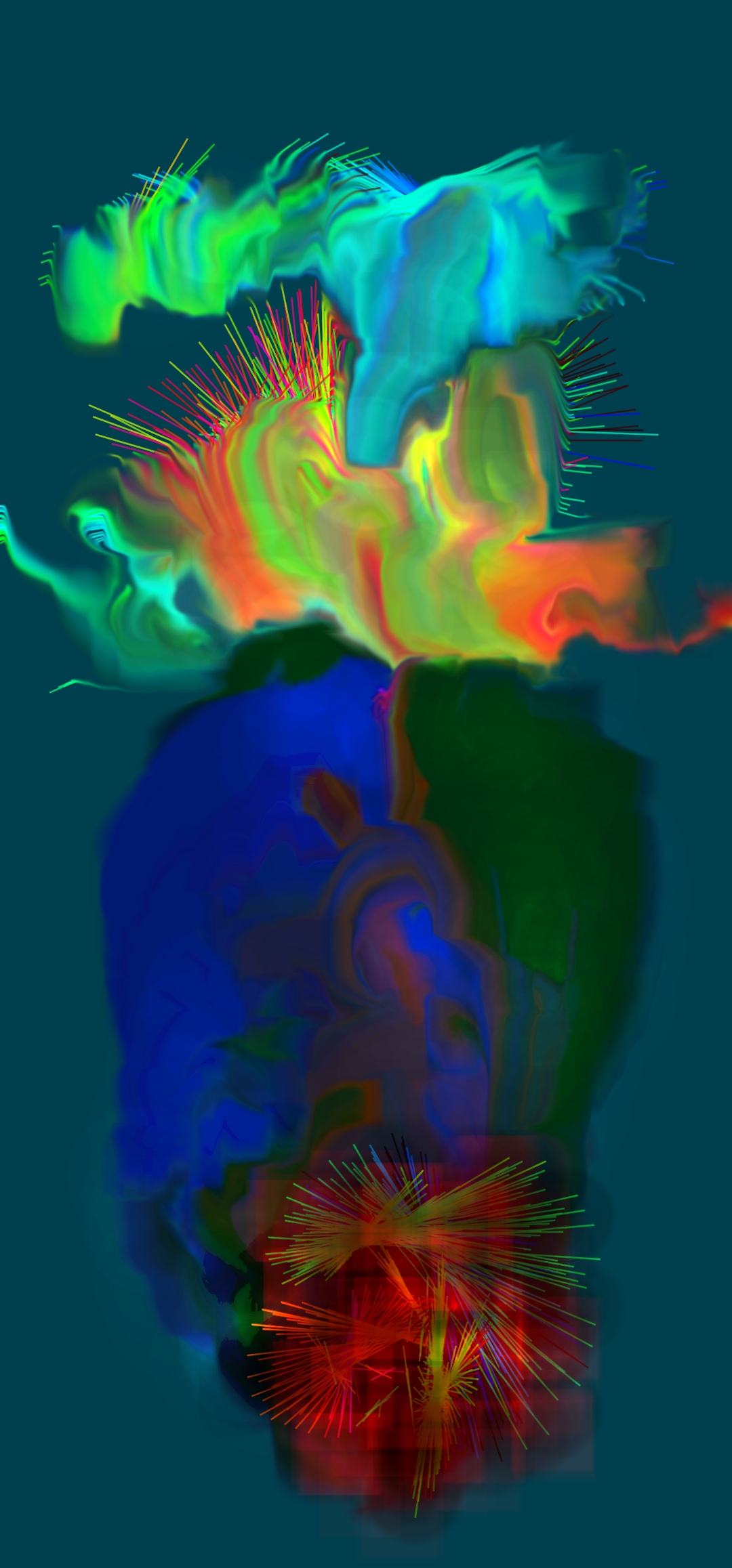عمر العسري
يتمتع الشعر بخصائص يصعب الإحاطة بها أو تحديد مكامنها مادام هو يُثير فينا العجب والدهشة إلى حد اعتبر كائنا حيا تتعدد مكوناته ومقوماته وأهدافه، علاوة على تفاوت سماته وملامحه، كما ينبثق عن ذوات متباينة المقاصد والمرامي، لذلك اختلف حول ماهيته واتفق حول وظيفته إلى حد ما.
وما يُثير العجب حقا هو طبيعة الموضوع الشعري، فكل قصيدة تتمثل موضوعا، نفترض أنه موحد لكن القيمة الفنية تتفاوت من شاعر لآخر ويبرز الحس التناولي للموضوع ونميل، نحن كمتلقين، إلى القيمة الفنية التي لولاها لظل الشعر قاصرا عن بلوغ وظيفته.
من هذه الزوايا، الموضوع الشعري والحس التناولي والقيمة الفنية، استوقفنا ديوان الشاعر أحمد العجمي “مساء في يدي”1، وهو في رأينا شعر يُثير قضايا عديدة من قبيل اللغة وحالات الذات، لكنه يبتني مكانا آخر غير معهود ومؤثث بعناصر الطبيعة ذات الملامح الإنسانية، أي الطبيعة المنخرطة في السلوك الفردي والتي عنها تدور الدلالة العامة وتتشكل وفق لغة مباشرة وعميقة لكنها لا تنفك عن بنية مكانية لا تبارح اللغة وإنما ترتبط بالفعل البشري وتبرز ككيان إبداعي صرف.
الاحتماء بالمكان
يحدد فهمنا للعلاقة القائمة بين المكان والشعر الحديث من خلال ارتباطين أساسيين، الأول كون المكان مقرون بالفعل الإنساني، والثاني يعكس المكان من بين ما يعكس خلجات ومشاعر وانفعالات الذات. في هذا التعلق بين المكان والشعر يعنينا التمييز بينهما ويسمح لنا برصد المكان في الشعر الحديث وفق المستويات التالية:
أ – مقاربة المكان بوصفه موضوعا شعريا مقترنا بموضوع النص.
ب- مقاربة المكان بوصفه كيانا وممارسة مرتبطين بالفعل البشري.
ج – مقاربة المكان بوصفه خلقا فنيا وحسيا للصورة الشعرية.
يبرز المكان في ديوان ” مساء في يدي ” باعتباره ممارسة ونشاطا مقرونين بفعل الذات وحالاتها، ونحن عندما نقرأ، على سبيل التمثيل قصيدة “سفر”:
كي لا أموت
أحلق ذقني
وألبس ثيابا
خارج توقعاتكم
اختار زاوية في المنزل
وأبدأ في الكشف
مواهبي
تتبدى لنا جمالية المكان بتقديم صورة عنه مختلفة عن المعهود، فالعلاقة التي تحيلنا القصيدة إليها هي المركبة بين اللغة والدلالات المؤشرة على جمالية الواقع من خلال المكان الذي يغدو نسقا بنائيا في الشعر، وكل قراءة لهذا المكان، في اعتقادنا، لا يجب أن تتناوله من زاوية طبيعية فقط، وإنما نعني القراءة التي تقرن المكان بالخلق الفني للصورة الشعرية والارتقاء بها إلى مصاف الجمال المادي للأشياء، بحيث تفقد الكلمات مدلولها أمام هيمنة مكانية جميلة حتى وإن كانت ضيقة: زاوية المنز، أو قليلة التحمل: سور حديقتي، أو حقيرة مهترئة: زنزانة فارغة.
يفقد المكان في الشعر ظاهريته فتبدو الحياة في القصيدة غير الحياة في الواقع، كما لو أن البناء الشعري المتكون من المكان يُصير هذا الأخير مادة لغوية عاكسة لإدراكات الذات والمتلقي، ولتأكيد طرحنا ندلل على سبيل التمثيل بهذا المقطع من قصيدة “نجوم”:
مسكين هذا الكوكب المريض
الجرافات تزهق عصافيره
الصواريخ
تصطاد زهرات الجبال
إن المكان الذي تؤشر عليه القصيدة ليس المكان المادي المباشر، وإنما المكان المتولد في مشاعر الشاعر، وهذا الوعي بالمكان، الكرة الأرضية كمكان شمولي، يتبدى من خلال تحويل الصورة المادية إلى صورة لغوية تخييلية بليغة، صورة تفرز لغويتها من خلال التراكيب والخصائص الفنية، ولكنها تسعى إلى التأثير على المتلقي ولفت انتباهه إلى قيمة المكان والخطر الذي يهدده. تخلق إذن هذه المكانية جماليتها من خلال التفاعل الشديد بين المكان كموضوع وككيان يستنبت أسئلة من قبيل الوجود والصراع. يقول الشاعر:
وعندما تُواجهني المرآة
أو يحضنني سرير بارد
تتفايض دموع
في صدري
لا أعرف مصدرها
صورة بسيطة ولكن أدواتها التعبيرية تنفذ خارج المكان الضيق الذي تؤشر عليه القصيدة: غرفة وسرير ومرآة، هذه العناصر تتحول إلى عوالم أكبر إذا ما تم التمعن في رمزيتها. لقد استطاع هذا الفعل اليومي في مكان ما أن يصنع لغته وهي تمتد إلى إحدى مدلولات المكان، وهي التحقق المباشر للفعل الإنساني وكأن الشاعر يصوغ جزءا من التاريخ العام. وغدا كل فعل إنساني في مكان معين إلا وهو مرتبط ارتباطا مباشرا بهذا التاريخ وكل تناول للمكان هو في اعتقادنا نظرة أخرى بملامح وجودية وكونية. وللتدليل على هذا القول نسوق مثالين حيث تتحقق المناسبة بين فعل الذات وحالتها وبين دلالة المكان الموظف لتلك الحالة. يقول الشاعر:
كيف أترك
ليلة مقمرة
أليست من الحكمة
أن أحضنك
وأترك الهواء يحرسنا؟
هذا كل ما سمعته
من ذكر حشرة الليل
وأنا
ذاهب إلى الفراش
وحدي
تحققت المناسبة، في هذا المقطع، بين فعل الذات وحالتها، وبين المحتضن للفعل، غرفة ذات فراش، وكلاهما يؤشران على وحدة قاتلة ومعاناة هي من صميم الوجود. وتمتد هذه المناسبة إلى قصيدة ” ثرثرة “:
في الحانة البليدة
كم أكرر حماقاتي
تماما
كما تفعل الصخور
أناقش أمورا فاسدة
ألصق الكلام
،على الطاولة
،وهذا ما يفعله
أصدقائي أيضا
لهذا
يصاب الليل بالخرف
بسط العنوان ظلاله على النص وقرن الذات بصفة الثرثرة حيث اللغو واللغط وأشكال الكلام غير المجدي، وهي أفعال إنسانية لا تتناسب إلا مع الحانة باعتبارها مكانا يرتبط ارتباطا مباشرا بهذه الأفعال. والشيء نفسه في قصيدة ” حزن “إذ تُقرن صفة الذات ” الحزن ” بمكان هو المشفى.
إن هذه المزاوجة بين المكان ومشروع الذات في التوحد مع نفسها لخطوة جديدة في تقرير صياغة أخرى للعـيش في كنف الوجود وهذا الميل غير المألوف لهذه الأمكنة هو إحدى النتائج المتولدة عن توالف المكان وحالات الذات.
موقف الشاعر من المكان شديد الوضوح بين قصائد الديوان، حيث تُرافقه البساطة في تناوله واستدعاء دقائقه التي منها يتشكل، ولأن المكان غربة وجودية في شعر العجمي فإن التعبير في هذا الشعر لا يستلهم لغة مجازية فحسب بل يناشد لغة الحياة وفق ما تنادي به حالات الذات وما تمور به التجربة الذاتية في وجدان الشاعر المحترق بعناصر الضوء التي يستعجلها في مبدإ ووسط ومنتهى الديوان.
– لن أجدكم وسأبقى أرسم المصباح الخارجي
– عندما سيأتي النهار سأكون بجانبه
– أقول وداعا وفي يدي وردة بيضاء
الهروب إلى الليل
القصيدة لدى أحمد العجمي انفعال وجداني يستجيب لنداءات الطبيعة بشقيها الحزين والسعيد، ولا ندري علام تكون النهاية مادام الشاعر قد اختار رحلة قاسية بفكرة الوحدة وإقصاء الآخر، حينئذ يضطر الشاعر إلى إشباع وحدته وإكسابها بعدا أنطلوجيا يعمل من خلاله على أنسنة عناصر الطبيعة. فقصيدة ” ظنون ” هي الافتتاحية التي تُلخص لنا مشهد الوحدة. يقول الشاعر:
لأن الشجرة
تزورني باستمرار
ولأن القناديل
لا تتكلم إلا بوجودي
ولأني
أُطعم النجوم لساني
كل هذا يحدث
وأنتم نائمون
ولهذا تعتبروني
خائنا
وكما كان الشاعر يتخير نموذجا ينتهجه في حياته فإنه هنا أيضا يستجيب لنداءات الليل، وكأنه يتحلل من القيود الاجتماعية ليجعل نفسه كائنا ميتافيزيقيا معلقا في الهواء. هكذا شكلت الطبيعة عود الثقاب الذي أشعل في وجدان الشاعر الابتعاد عن الناس والذي يفسر هذا تكثيف عناصر الطبيعة وأنسنتها وهي دعوة مباشرة من الشاعر نفسه نحو التحرر من المجتمع والتخلص من الغير.
الطبيعة عند أحمد العجمي جسد، أي تصدر عنها ردود أفعال إنسانية مثل: زيارة الشجرة، قول النهر، مرور موكب الليل، يقول الضوء، الشمس تتباطؤ…، والحق أن هذه الرؤية تنم عن جمالية التناول، فالجسد في العرف الاجتماعي يؤشر على الحركة والجمال والرشاقة، ولست أعتقد أن الشاعر تغيا هذه الإخراجات وإنما بالطبيعة كتب وعنها كان يدور في فلك غامض محوره الطبيعة الحية الناطقة وقد لا تفسر هذه الطبيعة، كما تبدت في القصائد، إلا بمقياسين:
أ- مقـياس الـضوء: تتكاثـف في نصوص الديوان عناصر الطبيعة الدالة على الضوء، وهذا دليل آخر على موقف الشاعر من مجتمعه، حيث اختار الابتعاد والتأسي بوحدته في حضرة النجوم وضوء القناديل، كما هو واضح في قصيدة ” ظنون ” المستشهد بها أعلاه. يؤكد أسلوب هذا النص على إثبات مباشر لعنصر الطبيعة ” الشجرة ” وأيضا للفعل الموجه إليها ” أطعم النجوم لساني “، كل ذلك يحدث في غياب الآخر، أو كما أسماه الشاعر” النائمون “. يحضر الليل دائما بغاية الاختلاء بالنفس أولا، والتحرر من وضاحة النهار ثانيا. يقول الشاعر في قصيدة “اختيار”:
كم أحب الليل
خاصة
إذا ما تركتموني
اقرأ كتابا
في الجنس
وأختار نجمة
لإضاءة سريري
يُشدد الشاعر في هذا المقطع على فعلين: الحب والاختيار، ويعلل ذلك بشيئين، أولا حبه لليل لأنه يخلصه من ضوء النهار الذي يشاركه فيه ما تبقى من الناس، وثانيا اختياره لنجمة من الليل حتى تضيء سريره وتؤنس وحدته. الإضاءة التي يبحث عنها الشاعر ليست ضوءا عاما أو مشتركا، وإنما الاستضاءة المبأرة على جسده وسريره، وكل شيء يراه صالحا لتحقيق المؤانسة له ولأشيائه. وقد تلعب الأشياء هنا دور المكمل لمقياس الضوء كالكتاب والسرير مثلا، لأن بهما لا يمكن مشاركة الآخر فعلي القراءة والاستلقاء. وهكذا يرنو مشروع الشاعر إلى تملك الإضاءة الليلية الطبيعية، وهي إضاءة خفيفة لكنها شبه فردية، أي تقتصر على الفرد دون الجماعة حسب مشروع الشاعر، وأيضا الاستعانة بالأشياء باعتبارها وسائط بين الشاعر والكون الضوئي لأن بها يُتمم مشروعه.
والمتأمل لنصوص الديوان يجد عبارات تسير في نفس الاتجاه، أي الطبيعة المشتعلة والمضيئة، لكنها تزاوج بين إضاءة طبيعية وأخرى مصطنعة وهو ما يمكن قراءته في هذه الأساليب المستأصلة من الديوان:
– ليلة مقمرة
– مصباح متدلي
– أستعيد ذاكرة النجوم
– يترك النجوم ترقص عارية
– صديقنا الضوء
تُشير هذه البنيات النصية إلى قيمة الليل ومكانته لدى الشاعر، وهو بذلك يُخلخل الثوابت الشعرية العربية القديمة، إذ كان الليل علامة كونية تحيل على الحزن والخوف واللامنجى وبه تشبه الهموم والبلاوي والمصائب، وقد يُقرن طوله بالإحساس النفسي الذي كان يُراود الشاعر وهو ينتظر النهار بصبر طويل. ولعل أول ما يستدعي الإضاءة في هذه الفرضية هو الأشعار التي قيلت في الليل. يقول النابغة الذبياني:
كليني لهم، ياأميمة، ناصب
وليل أقاسيه، بطيء الكواكب
ويقول امرؤ القيس:
وليل كموج البحر أرخى سدوله
علي بأنـواع الهـموم ليبتلي
قرن النابغة الليل بالقسوة والامتداد، وشبه امرؤ القيس ظلام الليل في هوله ونكارة أمره بأمواج البحر. إن قراءة البيتين في موضوع الليل يُمكننا من رصد الحكم التالي: علاقة الشعر بالليل وصراعهما مع خيبة الأمل، والخيبة هنا بوصفها موضوعا مقترنا بتصدعات الواقع من جهة وانتظارات الشاعر من جهة أخرى. ويقتضي تجريب هذه الفرضية قراءة متن يسوغها وذلك من خلال ما نستدعيه من أمثلة نصية.
يقول طرفة بن العبد:
أرى العيش كنزا ناقصا، كل ليلة
وما تنقص الأيام والدهر ينـفد
يستدعي الشاعر المنية ويعدها قدرا محتوما أمام عيش يتناقص باستمرار ليصير إلى الموت ولكل هذه التأملات زمن محدد هو الليل. وقد يمتد هذا الإحساس بالخيبة إلى التألم في الحياة كما تبدى في بيت الأعشى:
ويهماء بالليل غطشى الفلاة
يؤنسني صوت فيادها
يركز الشاعر على الإنسان المألوم إشارة إلى الملدوغ الذي يمنع من النوم لئلا يسري السم في جسمه، والبيت عامة يؤشر على الليل باعتباره كناية عن القلق.
ثمة اخفاق في مجاراة الليل والتأقلم مع معطياته، إذ عد زمنا للتألم والشعور بالخيبة، وهو إحساس ترجمته الخرافات الشعبية الإنسانية القائلة بكون الليل موطن الشياطين والأرواح الشريرة، وتضيف، من مات ليلا مضى إلى الجحيم.
إن الليل الذي يرصده الشعر العربي القديم يتواطأ مع الخيبة، فيما ليل أحمد العجمي يتكتم عن ذلك بمقاومة تنهض بها الدلالة العامة التي تصون شعرية النص، فآلية إحلال المرجعية النصية تتحقق على مستوى استدعاء الحقل الدلالي الليلي فقط، وهي كتابة على المنوال أو كما أسماها جيرا ر جنيت المعارضة، وإطار هذا المفهوم التعريف الذي خصه جنيت للمتعاليات النصية وأنماطها الخمسة. غير أن المعارضة تندرج تحت مفهوم أعم هو التعلق النصي، أي، كون كل نص مشتق من نص سابق بواسطة تبدل مباشر أو غير مباشر.
ما يحكم قصائد الديوان في توجهها إلى موضوعها هو تكاثر الأمل زمن الليل، فهي لا ترصد التفاصيل كما في الشعر القديم، لأنها وفية لتقديم الموضوع انطلاقا من مستويين:
مستوى التعلق الدلالي: تترجمه كلمة “الليل” بحمولتها النفسية والاجتماعية، وكأن الشاعر يحاكي الدلالة بالقلب، بدل أن يدعو إلى الاجتماع يسعى إلى الوحدة وهذا بعد آخر فرضته طبيعة التحضر واتساع التمدن.
مستوى الخرق الفني: بنى الشاعر نصوصه انطلاقا من كتابة سابقة ولكن استراتيجية هذه الكتابة تتغيا خرق الثوابت خاصة الفنية منها. ومن صور هذا الخرق:
* تكرار كلمة الليل ومشتقاتها كالنجوم والنوم والفراش والقمر… .
• التقطع الجملي الظاهر بين الأسطر الشعرية في مثل قول الشاعر:
جالسا على عتبة الباب
أنتظر مرور موكب الليل
الكتاب الذي في يدي
ظل صامتا
يصغي لحزن متوارث…
ما نلحظه في النص ضعف الترابط العضوي بين الأسطر الشعرية مما فسح المجال أمام تقطع جملي سمح بتعديدية قرائية ودلالية في الآن.
* تجاوب اللغة مع أمنية الوحدة.
ب- مقياس الحركة: أسندت الحركة إلى الطبيعة بغاية تمتيعها بدينامية شبه إنسانية وهو تبرير لمشاركتها الشاعر وجوده الخاص وذلك عبر عناصرها المستدعاة. يقول الشاعر:
عندما يعصرني النهار
أفكر في صديقي
الليل
يقرن فعل “عصر” بحركة اليدين، وكأن الأنا هنا غدت شيئا بين يدي النهار يعصرها بمعنى يبعثها على الاختناق والتقلص والتفكير في الخلاص. وما الليل في النهاية إلا ذلك المنقذ من ضلال النهار وأناسه، لا يفسر هذا الفعل الصادر عن النهار إلا برغبة جامحة من الأنا في البقاء رغم أنف الظروف، وهي رغبة مصوبة في اتجاه الحياة، ويمثل الليل تلك الحياة أو المنجاة من الموت ومبعث كل هذا العيش وحيدا وهو ما أشر عليه عنوان القصيدة “هروب”، إنه هروب من الآخرين، لأن النهار ليس هو المعني وإنما الوظيفة التي يمتع بها الناس ” العيش ” هي المقصودة.
لقد استشكل على الشاعر العيش مع الآخرين وفضل الانزواء وحيدا في غرفة ضيقة وسرير بارد، ولكن دفئه الحقيقي آت من ليل شبه طويل ونجوم خافتة ومصابيح معلقة يعبث بها الهواء. لقد فضل الشاعر الليل على النهار وقرن هذا الأخير بحركة الانصراف، وهي أمر بالمغادرة شريطة الرجوع. يقول الشاعر:
فعند ما يبدأ
النهار بالانصراف
تاركا سترته
على كتفي
كثيرا
ما ألجأ إلى كتاب نائم
أبحث عن
رائحة الأصدقاء
مؤشر فعل الانصراف على اعتراف الشاعر نفسه بسلطة الطبيعة في التبدل وسرمدية تعاقب الليل والنهار، وأن الإحساس الزمني الليلي لديه أقصر من الإحساس الزمني النهاري. وما قد يتبقى من النهار سوى رائحة أناس شاركهم الحياة لكن سيصادفهم حالما ينصرف الليل هو الآخر، مادام يمثل لحظة اطمئنان وارتياح للشاعر.
هذا التحلل من النهار هو في الآن نفسه تحلل من القيود الاجتماعية التي جعلت الشاعر كائنا وحيدا يتخير نموذجا ينتهجه في حياته مستجيبا لنداءات الليل وعناصره.
هكذا تكون قصائد “مساء في يدي” نتاجا لوحدة الموضوع وهي وحدة دينامية تؤالف بين عناصر الطبيعة وحالات الذات وما تعتمله في أمكنة شبه ضيقة لكنها تعكس وضعا معينا تخرجه الذات وتنسبه إلى حياة أخرى تتوالى فيها الصراعات والمآسي دونما تقرير مباشر.
إن صورة الحياة في مخيال العجمي هي وليدة أمكنة بسيطة مشوشة بتخييل يفهمه الشاعر الذي استفاد من التجارب الإنسانية فألمحت لغته على انسيابية متفجرة مشحونة بعاطفة ووجدان مما انعكس على حالة الذات وهي حبيسة أمكنة تشكلت من طبيعة الحدث.
إن اختبار فرضية المكان والزمان على ديوان أحمد العجمي قد سمح برصد رؤية الشاعر الحديث ومدى وعيه بشكل جديد من أشكال الكتابة انطلاقا من تمثله للموروث القديم ولكن بفعل كتابي مقاوم من اللغة وفيها، إذ تتحلل الصورة الشعرية وتنتسب إلى توجه رومانسي يحرص على مقاومة تصدعات الواقع باللغة وبالابتعاد ولو لهنيهات قصيرة.